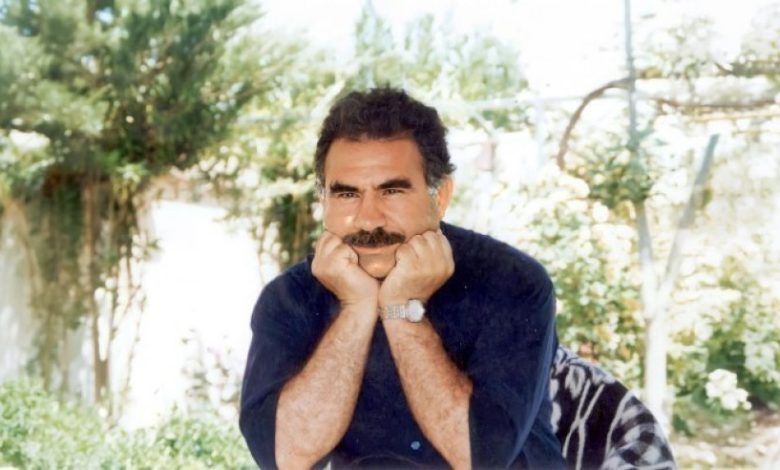
كانت مذهلةً فترةُ الشهورِ الأربعةِ الممتدةِ من 9 تشرين الأول 1998 حتى 15 شباط 1999. وما كان لأيةِ قوةٍ في العالَمِ عدا أمريكا، أنْ تُرَتِّبَ لهذا التمشيطِ الممتدِّ أربعةَ أشهرٍ بأكملها في تلك المرحلة. أما دورُ قواتِ الحربِ الخاصةِ التركية حينذاك (رئيسُها كان الجنرال أنكين آلان) فكان منحصراً في نقلي إلى إمرالي على متنِ الطائرة تحت الاشراف، كانت فترةً شاهدةً على تنفيذِ أهمِّ التمشيطات التي عرفَها تاريخُ الناتو بالتأكيد. وقد كان هذا ساطعاً بجلاء، لدرجة ان أي شخص لم يقم بأي تصرفٍ شاذٍّ في أيِّ مكان حللنا فيه. ومن فعل ذلك شل تأثيره على الفور. فحتى روسيا الكبرى شل تأثيرها بجلاء فاقع. في حين إنّ موقفَ اليونانيين كان كافياً أساساً لإيضاحِ كلِّ شيء. كما إنّ الإجراءاتِ الأمنيةَ المُتَّخَذةَ داخلَ وخارجَ المنزلِ الذي أقمتُ فيه بروما، كانت تسردُ الوضعَ إلى حدٍّ كبير. لقد اتَّخذوا تدابيراً استثنائيةً بخصوصِ الأَسْر. ولَم يَسمحوا حتى بخطوِ خطوةٍ واحدةٍ إلى خارج المنزل. وكانت وحداتُ الأمنِ الخاصةُ تراقبُ كل مكان بل وحتى باب غرفتي على مدارِ الساعةِ كانت حكومةُ داليما يساريةً ديمقراطية. وكان داليما قليلَ الخبرة، وعاجزا عن اتخاذِ قرارٍ بمفردِه. لقد جاب أوربا بأكملها. وبَيَّنَت إنكلترا له ضرورةَ اتخاذِه قرارَه الذاتيّ، ولَم تتعاونْ معه كثيراً. في حين كان موقفُ بروكسل غامضاً. وفي النتيجةِ أُحِلنا إلى القضاء. هذا وكان ممكنا عدمُ رؤيةِ تأثير الغلاديو في اتخاذِ هذا الموقف.
وبالأصل، فإيطاليا كانت واحدةً من البلدانِ التي يتمتعُ الغلاديو بالقوة الكبرى. كان برلسكوني قد استنفرَ كافةَ قواه. وهو بذاتِه كان رجلَ الغلاديو. وعليه كنتُ مُرغَماً على الخروج. لأنني علمت بعدم قدرة إيطاليا على تحمّلي. بالطبع كانت تركيا قد صُيِّرَت مقابل ذلك واحدةً من أكثرِ البلدانِ التي تَثِقُ بها أمريكا وإسرائيل، بعدَما جعلتاها تَدورُ في فلكِهما. من هنا، فالسياقُ الذي يزعم أنه عولمة طائشة ما هو في واقعِ الأمرِ سوى حكايةُ تقديمِ تركيا هِبَةً للرأسماليةِ الماليةِ العالمية.
أوليتُ الأولويةَ لمفهومِ مرافعةٍ تضعُ ماهيةَ المؤامرةِ الدوليةِ نُصبَ العينِ فيما يخصُّ سياقَ إمرالي. فالمتحركون باسمِ التركياتيةِ كانوا قد بتَروا أواصرَهم مع الحقيقة، بسببِ وعيهم التركياتيِّ المتشدد. بالتالي، فإدراكُ الفلسفةَ الكامنة وراء المؤامرة، كان يخالف طبيعتهم، لأنهم – هم أيضاً – ثمارَ البنى التي شادَتها فلسفةُ المؤامرةِ تلك طيلةَ مئةِ عامٍ على الأقلّ. وعليه، كان من غيرِ المتوقَّعِ أنْ يتنكروا لتلك البنى المُشادة، أو يتناولوها بعينٍ ناقدة. كما وكان لا طائل من التعويل علىِ أنْ يُبدوا أيةَ إرادةٍ للتغيرِ الإيجابيِّ، سواء أثناء كوميديا المحاكمة، أم خلال مرحلة الاعتقال. أما تصديقُ أنه سيتمُّ التصرفُ بمقتضى الأقوالِ التي همَسَ بها ممثلُ رئاسةِ الأركانِ العامة، فكان سيغدو سذاجةً في ظلِّ الظروفِ القائمة. فبالأصل، إنهم مجرَّدون من قوةِ القرارِ التي تُخَوِّلُهم لتطبيقِ أقوالِه. لقد ابتُكِرَ نظامٌ تدعمُه أمريكا في الخفاء، ويشرفُ عليه الاتحادُ الأوروبيّ. وانكلترا من صمم هذا النظام، في حين أنّ تطبيقَه كان من حصةِ الأتراك.
من عظيمِ الأهميةِ استيعابُ الذهنيةِ الفلسفيةِ والسياسيةِ الكامنة خلف المؤامرة. ولذلك أتحدثُ مِراراً وتكراراً عن خلفيةِ المؤامرةِ التي تشملُ عصراً بأكملِه، وأُصَرِّحُ بذلك في كلِّ فرصةٍ مواتية. كما وتطرقتُ إلى المؤامراتِ التي تُعَدُّ حجرَ زاويةٍ في عهدِها. ومنها فيما يتعلقُ بالكردِ فحسب: مؤامرة الألوية الحميدية، مؤامرتا قتلِ الملا سليم في بدليس والشيخ سعيد في 1925، ومؤامرتا آغري 1930 وديرسم 1937، قضية الـ49 عامَ 1959 وقضية الـ400 عامَ 1960، قتل فائق بوجاق، مقتل سعيد قرمزي توبراق على يدِ KDP، إضافةً إلى المؤامراتِ التي يمكن ذكر المئات منها دفعة واحدة، والممتدةُ منذ المرحلةِ الأيديولوجيةِ لـPKK إلى يومِنا الراهن، والتي تُحاكُ من طرفِ العقليةِ عينِها. إنّ مُدَبِّري المؤامراتِ يَعتبِرونها فناَ سلطوياً مُرَتَّباً ببراعةٍ فائقة. أنّ المؤامرةَ بمنزلةِ الروحِ في فنِّ السلطة، أو هي أهمُّ وسيلةٍ فيه. وكان من الضروريِّ تسييرِ هذا الفنِّ بالنسبةِ إلى الكردِ على خلفيةِ المؤامرةِ دون بد. ذلك أنّ تنفيذَ المؤامرةِ بأسلوبٍ علنيّ، كان سيفضي إلى قولِ الطفل: “انظري يا أمي، المَلِكُ عارٍ”. ومن هنا فقوةُ السلطةِ التي تَهدفُ إلى تطبيقِ أفعالٍ تَصِلُ حدَّ التطهيرِ الجماعيّ، سوى المؤامرةُ والعقليةُ التي تُحَدِّدُ مسارَها. المهمُّ هنا هو التعرفُ الصحيحُ على القوى المندرجةِ في سياقِ المؤامرة، والتعريفُ السليمُ لها.
عليَّ التبيانُ بأني لاقيتُ صعوبةً في هذا الموضوعِ خلال سياقِ إمرالي. فموضوعُ الحديثِ هنا هو تواجُدُ قوى متنافرةٍ إلى أبعدِ حدٍّ ضمن المؤامرة. حيث أُدرِجَت كثيرٌ من الدولِ ضمنها، بدءاً من أمريكا إلى روسيا الاتحادية ومن الاتحادِ الأوروبيِّ إلى الجامعةِ العربية، ومن تركيا إلى اليونان، ومن كينيا إلى طاجكستان. فما الذي كان قد وَحَّدَ الأتراكَ واليونانيين بعدَ عداءِ عصورٍ بأكملِها؟ ولِمَ كان يُعقَدُ على حسابي كلُّ هذا الكمِّ من التحالفاتِ أو اتحاد المنافعِ غيرِ المبدئية؟ زِدْ على ذلك أنّ الأتراكَ والكردَ اليساريين والقوميين المتواطئين المغتبطين في قَرارةِ أنفسِهم جراء استهدافي، كانوا كُثُراً لدرجةٍ لا تُعَدُّ ولا تحصى.
وكأنّ العالَمَ الرسميَّ قد أوقَعَ أخطرَ رقيبٍ له في الفخِّ متجسداً في شخصيتي. وضمن PKK أيضاً، كان من العصيبِ الاستخفافُ بتعدادِ أولئك الذين اعتقدوا بأنّ اليومَ يومُهم، وأنه آنَ الأوانُ ليعيشوا على هواهم. لكنّ ما لا جدال فيه، هو أنّ تعريفاً عاماً للأمر منذ البداية سيَبسطُ للعَيانِ كونَ كافةِ تلك القوى تتشكلُ من الشرائحِ التي تحتلُّ الصَدارةَ في لائحةِ اللاهثين وراء المنافعِ الليبراليةِ للحداثة الرأسمالية. وأنا كنتُ خطراً يهددُ المصالحَ والعقليةَ الليبراليةَ الفاشيةَ لِجُلِّهم.
فمثلاً؛ إنكلترا هي الأكثر خبرةً من بين تلك القوى. وهي القوةُ التي أطلقَت الإنذار الأولِ بعدمِ السماحِ بمزاولتي السياسةَ ضمن أوروبا. وما أنْ وطأَت قدماي أرضَ أوروبا، حتى سارعَت لإعلاني “persona non grata” أي “الشخص المنبوذ”. لَم تَكُ هذه خطوةً بسيطة، بل كانت من الخطواتِ التي تقررُ النتيجةَ النهائيةَ سلفاً. حسناً، ولماذا اتُّخِذَ إزائي هكذا موقفٌ فوريٌّ لَم يُتَّخَذْ حتى إزاء خميني أو لينين؟ لقد سعيتُ إلى توضيحِ العديدِ من البوادرِ والعلائمِ المعنيةِ بذلك في العديدِ من فصولِ مرافعتي. لذا، لا داعي لمزيدٍ من التكرار. وباقتضاب؛ كنتُ حجرَ عثرةٍ لا يُستَهانُ به على دربِ حساباتِ الهيمنةِ المُعَمِّرةِ قرنَين من الزمنِ بشأنِ الشرقِ الأوسط، وبالأخصِّ بسببِ سياساتِها المتعلقةِ بكردستان (باختصار، بسببِ السياسةِ التي مفادُها “إليكَ كركوك والموصل، واقضِ على الكردِ داخل حدودك”). وكنتُ قد أمسيتُ خطراً يهددُ كلَّ مخططاتِها، ويقضُّ مضاجعَ منفذيها.
أما هَمُّ أمريكا، فكان مختلفاً. كانت لها مطامعُها في تمرير “مشروعِ الشرقِ الأوسطِ الكبير” لذا، اتسمت التطورات في كردستان بأهميةٍ حياتيةٍ وحرجة. بالتالي، فإن شَلُّ تأثيري بصورة أكيدة، كان ضرورةً من ضروراتِ الأجواءِ الحرجة حينذاك. بأقل تقدير. هذا وكان القضاءُ عليُّ يتناسبُ مع السياساتِ العالميةَ في تلك الأيام. أما روسيا التي كانت تمرُّ بأزمةٍ اقتصاديةٍ بالغةِ الأهميةِ في تاريخِها، فكانت في مسيسِ الحاجةِ إلى قرضِ مَعونةٍ عاجلة. ولَئِنْ كان سيصبحُ دواءً لدائِها، فلن يبقى أيُّ سببٍ لعدمِ لعبِ دورِها واحتلالِ مكانِها في المؤامرةِ المُحاكةِ ضدي. أما الآخرون، فكانوا من الأساسِ “كالإخوةِ الصغارِ المهذَّبين والطائعين لأخيهم الأكبر” الذي يُعَدُّ تاجاً على رؤوسِهم، أيا كان كلامه. في حين إنها كانت فرصةً سانحةً لأجلِ كلٍّ من اليسارِ التركيِّ (عدا الاستثناءات) والمتواطئين الكردِ والمستائين داخل PKK، كي يتخلصوا من ند ذي شأن. في نهايةِ المآل، فالفلسفةُ الكامنةُ في الأغوارِ السحيقةِ لجميعِ هذه المواقف، كانت فلسفةَ المصالحِ اليوميةِ والمنفعيةِ والأنانيةِ في الليبرالية.





